بمعزل عن الموضوع – سلام الكواكبي
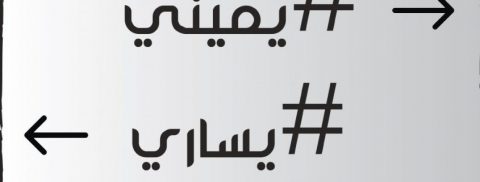 هالني هذا التعبير، على الرغم من لطافته، عندما سمعته بعد عرض مؤثّر لفيلم “مسكون”، للمخرجة والشاعرة السورية لواء اليازجي، في المهرجان الثقافي السوري في مدينة بريمن الألمانية؛ إذ تقدّم منها أحد الحاضرين السوريين، مُشيدًا بجمالية اللقطات، وحسن اختيار الشخوص الموثقة حيواتها، ولكنه استبق كل هذا المديح الجمالي بهذه العبارة التي سحبت منه جُلّ الدسم؛ قولٌ لا يُراد منه المساعدة في التعبير لمن اختار الوقوف على الحياد، حيال موضوعة الفيلم الرئيسة المرتبطة بالشأن السوري، بل هو موقفٌ واضحُ السلبية من رسالة الفيلم/ الوثيقة.
هالني هذا التعبير، على الرغم من لطافته، عندما سمعته بعد عرض مؤثّر لفيلم “مسكون”، للمخرجة والشاعرة السورية لواء اليازجي، في المهرجان الثقافي السوري في مدينة بريمن الألمانية؛ إذ تقدّم منها أحد الحاضرين السوريين، مُشيدًا بجمالية اللقطات، وحسن اختيار الشخوص الموثقة حيواتها، ولكنه استبق كل هذا المديح الجمالي بهذه العبارة التي سحبت منه جُلّ الدسم؛ قولٌ لا يُراد منه المساعدة في التعبير لمن اختار الوقوف على الحياد، حيال موضوعة الفيلم الرئيسة المرتبطة بالشأن السوري، بل هو موقفٌ واضحُ السلبية من رسالة الفيلم/ الوثيقة.
وكثيرًا ما يُبحر بعض المعلّقين على المداخلة السياسية أو الثقافية، وممن يتبنون موقفًا عدائيًا تجاه سعي الناس إلى الحرية، أو على الأقل، ممن يتمايلون بين المواقف المتضاربة ويتلونون برماد الكلام، يُبحرون في أمواج اللغة والألفاظ؛ للابتعاد عن صلب الموضوع، أو للتهرّب من مواجهة حتمية الالتزام حول مسألة بذاتها؛ ويتم ذلك -خصوصًا- عندما تكون هذه المسألة تمسّ الشأن الخلافي في التموضع المبدئي والأخلاقي من مقتلة، تستمر مجرياتها وتتشابك معطياتها وتتماسك أطرافها.
جميع من يُحاضر في المسألة السورية، أو يعرض فيلمًا عنها أو يُشارك في حوار حولها، صار متيّقنًا من صيغة الأسئلة والملاحظات والتعليقات، ممن لا يوافقون -بالرأي وبالموقف- مضمون خطابه السياسي او الفني؛ هؤلاء، يبدؤون بالإطراء الشكلي لما ورد أو قيل أو عُرض ليصلوا إلى كلمة: (ولكن) المقدسة، وهي تحمل في جنباتها كل السلبية التي تختلج مشاعرهم تجاه ما تابعوه، ومن النادر أن يبدأ أحدهم تعقيبه بالتطرق فورًا إلى حمولته النقدية بشجاعة وتجرّد؛ فصار الواحد منّا، وعند سماعه مقدمة عبقة التعابير، يتندّر بينه وبين ذاته عن اللحظة التي ستخرج فيها هذه العبارة التي ستنقض كل ما سبقها، وتؤسس لخطاب سلبي، يمكن أن يتحول إلى هجومي إن ساعدته لغة الجسد.
من جهة أخرى، يُبدع بعض المعلقين في إقحام المقارنة في كل شاردة وواردة، فإن تكلمت عن جرائم نظامٍ بعينه وفساده وسياساته التدميرية للزرع والضرع، فتأكد بأنه سيخرج لك من ينتقد انتقائيتك غير المتوازنة، سيقوم بذلك مستعرضًا، عن علمٍ أو عن جهلٍ، جرائم وفساد دولٍ أخرى، لم تكن في صلب موضوعك المُعلن ومحاضرتك المقررة، وهو سيغمز من زاوية ما ليُحاول التقليل من وقع ما أثرته بوضعه في إطار مقارنة خالية من المنطق، مع حدث آخر في نطاق آخر وفي معطيات أخرى. فكم من مرة سمعنا، وقرأنا، من يهرب من مصيبته الوطنية؛ ليتلظّى بمقاربات ومقارنات فاهية تضع إسرائيل في واجهة منطقٍ أعوجٍ بامتياز؛ حيث لا يمكن أن يتم التطرّق إلى مسألة الحريات في العالم العربي، دون أن تواجه بخطاب خشبي ناري يذكّرك بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين، ويمكن تعزيز هذا الخطاب الكرتوني بلازمةٍ وطنية تحثّك على تأجيل المطالبة بالحرية إلى أن يحصل عليها الفلسطينيون، كما وستقع في مستنقع التخوين الأكثر انتشارًا، إن ميّزت قضيتك عن القضية الكبرى، وإن رأيت أن حل مسألة الحريات في الدول العربية هو الطريق الأقصر إلى فلسطين، وليس قتل المدنيين وتدمير ديارهم.
كما أن القدرة على الهروب إلى الأمام تنمو أكثر فأكثر؛ بحيث أن من يبحث عن تفكيك منهجك أو نقضه، سيرتمي في نهرٍ من الكلمات المترادفة حول لا ديمقراطية الغرب، وانتهاكات حقوق بعض من في دوله. وإن كان “بافلوفيًا” من بعض اليسار الذي لم يَبلغ بعد، على ما يبدو، ويظهر في انهيار الاتحاد السوفياتي، فمن المُحتّم أنه سيتوسّع في تحليل دور رأس المال، المهيمن على سياسات واستراتيجيات الدول “الديمقراطية”، وسيستعرض دور الشركات متعددة الجنسيات في سلب شعوب العالم الفقير ثرواتها، مصرّحًا بتضامنه مع شعوب زيمبابوي ونيكاراغوا، أو غيرها من التنويعات القارية.
وبالتالي، فسيظهر خطابك وكأنه إعجابٌ ساذج بديمقراطية ليست بالديمقراطية، وبحرية ليست بالحرية. عسى ولعل هذا التوبيخ يُفضي بك إلى أن تعود إلى جادة الصواب، وتخرس عن التحليل المرتبط بنظريات علمية “إمبريالية”، حينًا أو مواقف سياسية تُحابي فيها مبادئ الغرب “الفاسد” و”المُنحلّ”، وحتى لو حاولت الهروب من المسائل الإشكالية، وملت إلى الحديث عن زراعة البطيخ في المناطق الجافة، فستجد حتمًا من يقابلك بالتنديد لأنك لم تتطرّق إلى زراعة العدس في ذات المناطق، وسيبحث عن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية لنأيك بالنفس عن مثل هذا الطرح المهم.
لا يختص أترابنا بهذه الثقافة “التعليقية” التي تقضّ مضاجع المنطق، بل يتوافر في الغرب “الإمبريالي” أشباه لهم، يكاد المرء أن يُصنّفهم في ثلاث:
اليساري البافلوفي -دائمًا- المتشبث بمبادئ لم يقرأها، وبعقيدة لم يمارسها، وهو ممن يسمح لنفسه بتقييم الثورات، وتسفيه سعي الشرقيين إلى الحرية، وهو أشد شراسة في “ثقافويته” من برنار لويس، وكثيرًا ما يربط هذا الصنف الرديء الثورات أو الحركات الاحتجاجية القائمة في الدول العربية بمخططات إمبريالية – صهيونية – ماسونية – …إلخ، وصارت مناقشته بالحسنى والهدوء تسمح باكتساب الجنة.
وهناك ذاك الآتي من بلداننا، ولكن لديه مشكلة مع ثقافته الأم، ويُحاول أن يتبرأ منها ومن غبارها عادًّا ذلك هو خير سبيل للاندماج؛ فهو سيخرج عليك بتعليقات استشراقية أين منها عُتاة المستشرقين، مصنّفًا الناس بحسب الأديان وقابليتها للمبادئ التحررية، وهو قد فهم أيضًا بأن العزف، ولو لحنًا نشازًا، على أوتار “الإسلاموفوبيا”، يُفضي إلى اندماجه السريع في مجتمع، يخاله يُحب من يشتم ذاته، ويزاود على عتاة يمينييه المتطرفين، في تسفيه سعي الشرقي، أو العالم ثالثي عمومًا إلى الحرية والتحرر.
وأخيرًا وليس آخرًا، يبرز اليميني المتطرف الذي يُغلّف موقفه بمسحة دينية غير تسامحية، تبرز داعشيتها في التعبير، ولا تنتقل حتى الآن إلى الممارسة، وحجته الأساسية في الهجوم والتصدي هي مسألة حقوق الأقليات، وكيفية حماية استمرارية وجودهم في المنطق، وهو غالبًا ما يقول مثلًا: فلانٌ من الزعماء دكتاتور؛ ولكن لا مناص من وجوده لحماية الأقليات.
“بمعزلٍ عن الموضوع″… فكل ما سبق، ليس إلا ملاحظات لها علاقة بمن يُغامر ويُحاول أن يُعالج المسألة السورية بأبعد مسافة عن “البروباغندا” الحماسية، ومن يسعى إلى استعمال أدوات التحليل العلمية وفق منهجية محددة، واستنادًا إلى مراجع بحثية موثّقة، ومن شبه المؤكد أن من يُمارس الخطاب الخشبي، ولو كان ثوريًا، فإنه سيتمكن من مواجهة مثل هاته المواقف بقدرات صوتية، وربما عضلية أكثر تأثيرًا. إن الطيور على أشكالها تقع